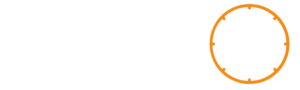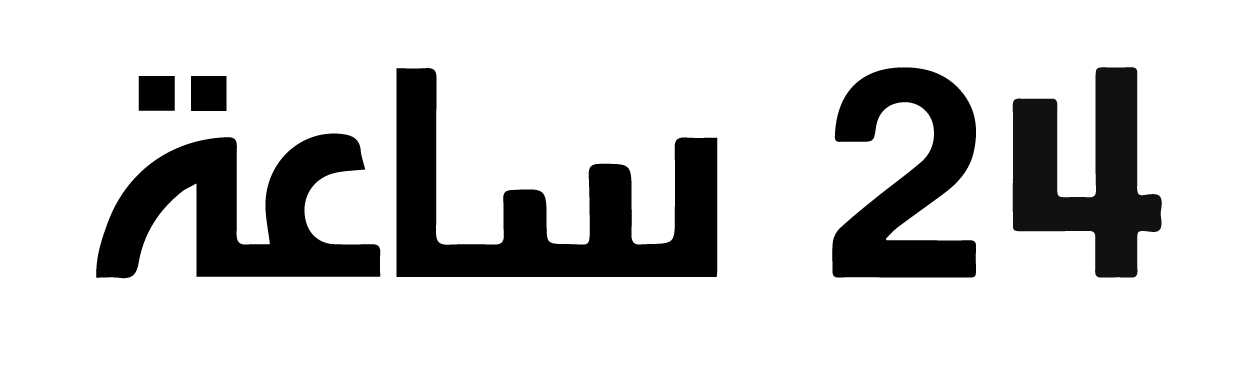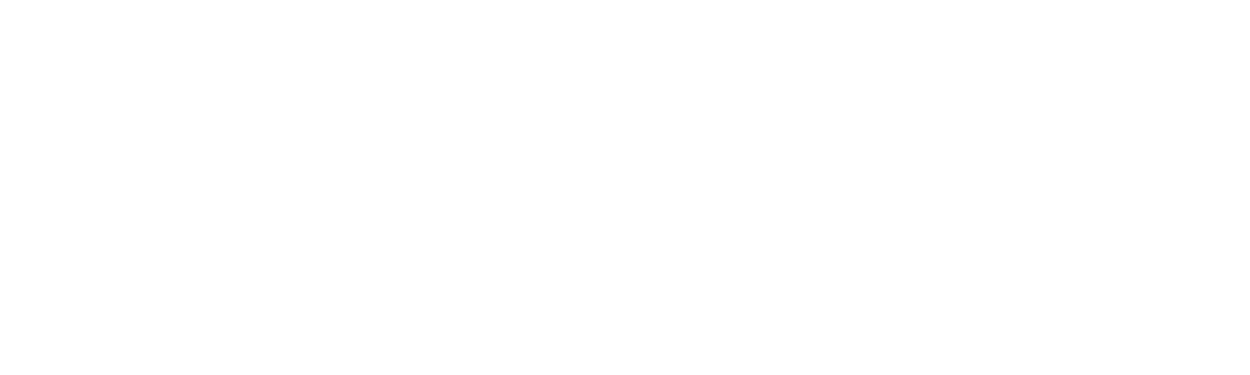24 ساعة-عماد مجدوبي
تعبر ظاهرة “الكريساج” أو السطو بالعنف من أبرز السلوكيات الإجرامية التي تشغل بال الرأي العام المغربي، نظرا لما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية وأمنية خطيرة، سواء على الضحايا أو على المجتمع بشكل عام.
وفي هذا السياق، قدم عبد الرحيم عنبي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، قراءة تحليلية لهذه الظاهرة، انطلاقا من ثلاث مستويات مترابطة: المستوى الثقافي التاريخي، والمستوى الاجتماعي الفردي، ثم المستوى الأمني والنفسي.
وقال عنبي في تصريحه لـ”24 ساعة” إن “الكريساج” ليس سلوكا طارئا على المجتمع المغربي، بل له جذور عميقة في التاريخ، حيث كانت المجتمعات القبلية، سواء في المغرب أو في بلدان أخرى، تعتمد على الهجوم والنهب كوسيلة من وسائل البقاء والسيطرة.
وأكد أنه في تلك الفترات، كانت القبائل تهاجم بعضها البعض وتسلب الممتلكات، في ظل غياب الدولة أو أي شكل من أشكال السلطة المنظمة.
وهذا السلوك، وإن تغيرت صوره وأشكاله اليوم، لا يزال يحمل امتدادا ثقافيا لدى بعض الأفراد الذين نشأوا في بيئات تفتقر إلى الانضباط المؤسسي والتربوي، سواء في الأسرة أو في المدرسة أو في المحيط الاجتماعي العام.
وهكذا، يتبنى بعض الأشخاص عقليات لا تؤمن بوجود حدود قانونية أو أخلاقية، وينظرون إلى الآخر كهدف مشروع للنهب، دون اعتبار لانتمائه الديني أو الثقافي أو الاجتماعي.
أما على المستوى الثاني، ركز عنبي على الجانب السوسيولوجي الفردي، مبرزا أن من يمارس “الكريساج” ليس دائما ضحية حاجة اقتصادية، بل قد يكون أيضا ضحية فشل ذاتي أو عزلة مجتمعية.
وبحسب المتحدث، فهؤلاء الأفراد، قد لا يمتلكون مؤهلات مهنية أو علمية، ويفتقرون إلى الرغبة أو القدرة على التكوين والانخراط في المجتمع بشكل طبيعي.
وهنا يظهر مفهوم “اللا معيارية”، حيث يصبح الشخص غير خاضع للمعايير القانونية أو الأخلاقية، ويلجأ إلى العنف والنهب كوسيلة لتحقيق إشباع لحاجاته، ولو بطرق غير مشروعة.
ويضيف عنبي أن كل إنسان يحمل في داخله قوتين، قوة بناءة تمكنه من التكوين والعمل والمساهمة في بناء المجتمع، وقوة هدامة تدفعه نحو الفوضى والانحراف، خاصة إذا تعطلت آليات التربية أو انعدمت فرص التكوين والاندماج.
وفي حال غياب هذه القوة البناءة، وافتقار الفرد إلى منظومة قيمية ومؤسساتية حاضنة، فإن القوة الهدامة تطفو على السطح وتترجم إلى سلوكيات خطيرة مثل “الكريساج”.
أما على المستوى الثالث، فقد أشار الأستاذ عنبي إلى أن المقاربة الأمنية، على أهميتها، تظل غير كافية لوحدها في مواجهة هذه الظاهرة، فالأمن يتدخل غالبا بعد وقوع الجريمة أو بناء على تبليغات المواطنين، ولا يمكنه تغطية كل جوانب الظاهرة.
ودعا عنبي إلى ضرورة تبني مقاربة شمولية تدمج الأبعاد النفسية والاجتماعية والثقافية، مع تعزيز أدوار التوجيه والإرشاد داخل المجتمع.
ويؤكد عنبي أن الأشخاص الذين يمارسون السطو والنهب يعيشون غالبا اضطرابات نفسية واختلالات اجتماعية عميقة، تجعلهم خارج الإطار القانوني والأخلاقي.
ولهذا، فإن معالجة الظاهرة تتطلب مجهودا مجتمعيا مشتركا، لا يقتصر على رجال الأمن فقط، بل يشمل أيضا الأسر والمدارس والجمعيات والإعلام والفاعلين الاجتماعيين، من أجل التأثير في السلوك الفردي، وخلق وعي جماعي رافض لمثل هذه السلوكات العنيفة.
وخلص الأستاذ عبد الرحيم عنبي إلى أن الحل الحقيقي يكمن في الوقاية الاجتماعية، وفي إعادة بناء الثقة بين الفرد والمؤسسات، وتوفير شروط الاندماج الإيجابي في المجتمع، حتى لا تتحول الطاقات المعطلة إلى قوى هدامة تسعى إلى التدمير والنهب بدل البناء والمشاركة، فظاهرة “الكريساج”، وإن بدت جريمة فردية، فإنها في عمقها مرآة تعكس اختلالات متعددة تستوجب إصلاحا شاملا.