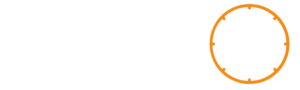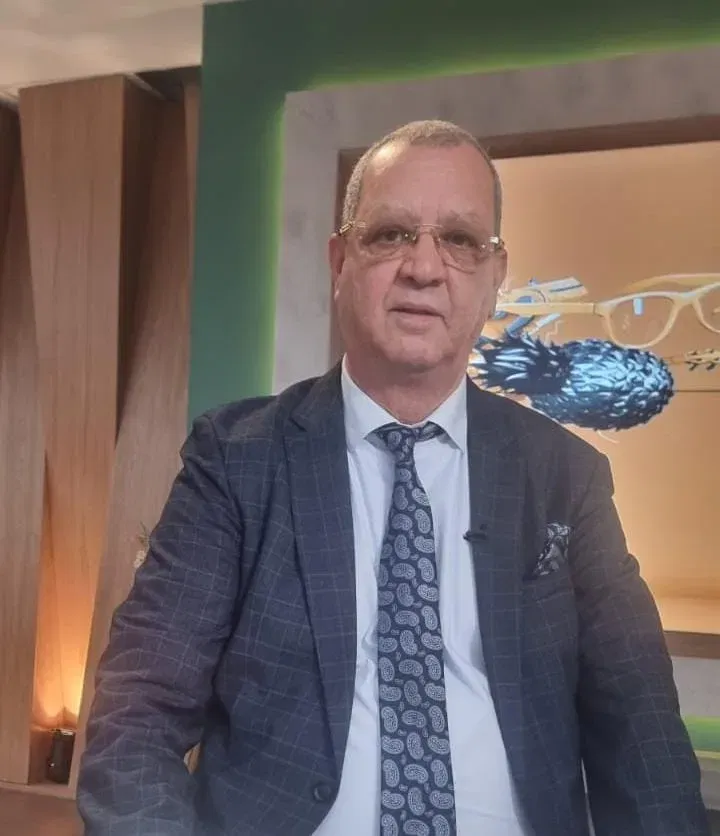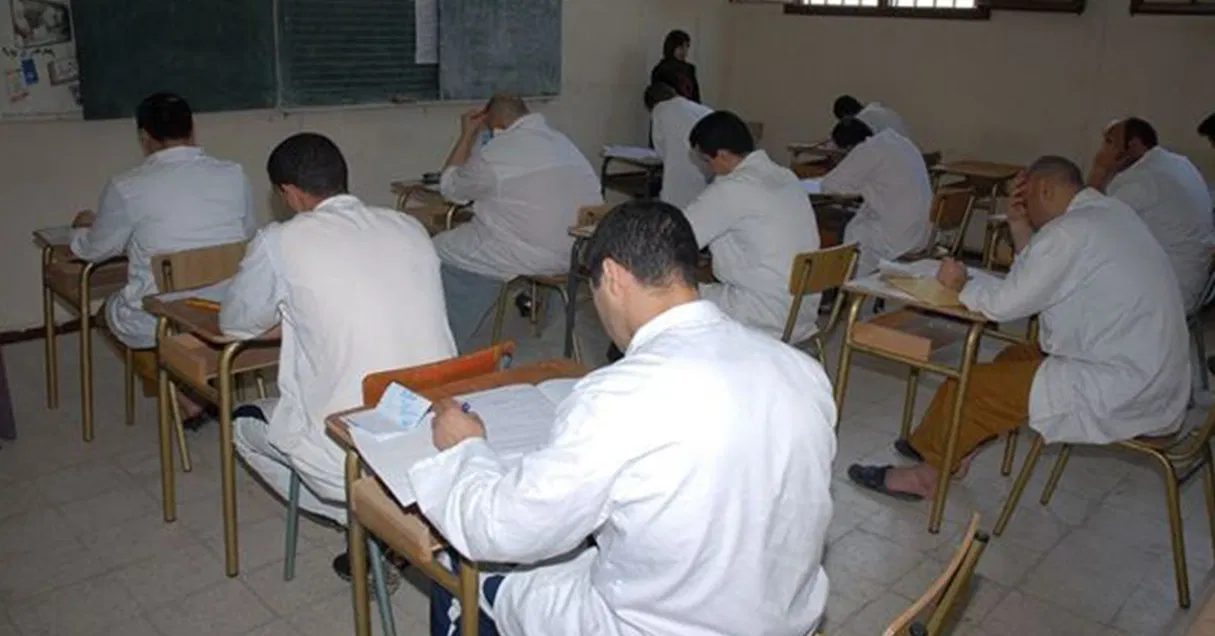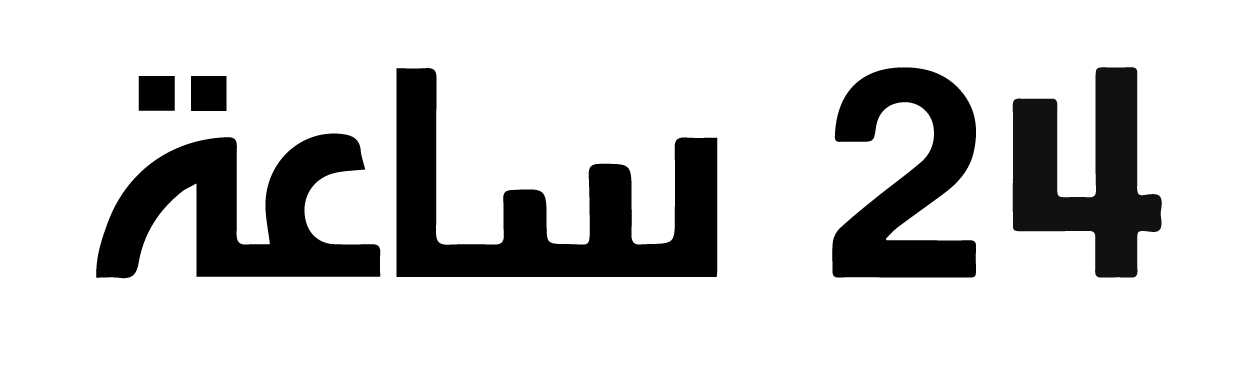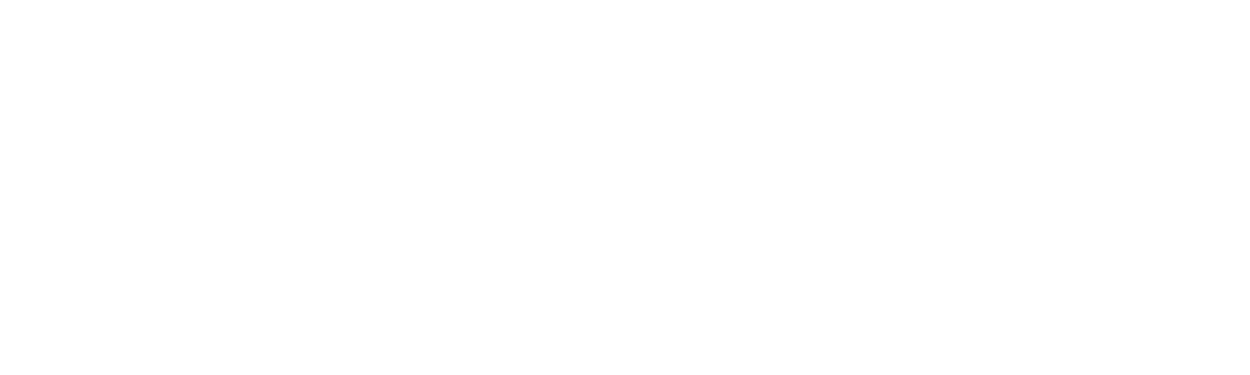ذ/ يوسف عبد القاوي
إن موضوع الإثبات في المادة الجنائية يعنى بوجود الجريمة في حد ذاتها ومدى توفر أركانها، وفي هذا السياق تنهل التشريعات من نظريتين وهما: “نظرية حرية الإثبات” و”نظرية الإثبات المقيد”، ويعتبر القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 من بين القوانين المكرسة مبدئيا لنظرية حرية الإثبات، من خلال المادة 286 من ق.م.ج التي تنص على أنه: “يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده.
إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته“.
ويلاحظ من خلال أحكام الفصل المذكور أن المشرع ربط مبدأ حرية الإثبات بمبدأ آخر لا يقل عنه أهمية في المادة الجنائية وهو مبدأ “قناعة القاضي” الذي أقر كضمانة لعدم التعسف والإفراط في حرية الإثبات، فالقاضي الزجري هو الضامن للمحافظة على التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق المشتبه فيه.
ويقتضي مبدأ “القناعة الشخصية” للقاضي أن يكون للقاضي سلطة تقديرية كاملة في تقييم كل دليل على حدا فيأخذ من الأدلة ما تتكون به قناعته ويطرح جانبا ما لا تطمئن إليه.
إن القانون منح القاضي في المسائل الجنائية سلطة واسعة وحرية كبيرة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها وفتح له باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يؤدي به إلى الكشف عن الحقيقة وله حرية كبيرة في تقييم ما يعرض عليه منها، همه الوحيد هو الحقيقة ينشدها ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده.
وعلاقة بالنقاشات الدائرة حول تعديل قانون المسطرة الجنائية، لا شك أن أي تعديل لهذا القانون لا يستحضر ضرورة معالجة آفة “المساطر المرجعية” وهي تسمية إدارية ل”شهادة متهم على آخر” والتي تتعلق ببحث أو اعتراف أو تصريح أو بإدانة متهم ذكر متهم آخر أنه شريكه فيؤتى به للبحث والتحقيق والمحاكمة على أساس تصريحاته، والتي للأسف تحولت إلى أصل عوض أن تشكل استثناء، وحلت محل التلبس أو كادت، وأصبحت تعتمد كوسيلة إثبات رغم كونها غير منظمة قانونا، ورغم كونها تشكل خطرا على الحرية وتمس بقرينة البراءة، وتفتح باب التعسف، أقول أن أي تعديل لهذا القانون، سيكون منعدم الجدوى وبغير إضافة لحماية الحقوق والحريات.
إنها مساطر لا أصل ولا فصل ولا فرع لها، فهي غير مؤسسة على أي مادة من القانون، ولا على عمل قضائي ثابت ومستقر لمحكمة النقض، فلا هي مؤهلة لحماية الحقوق، ولا ضامنة لصيانة الحريات، ولا مراعية للأمن القانوني والأمن القضائي ولا تمت إلى التطبيق العادل للقانون، إنما هي عنوان حيف الممارسة القضائية، والتطبيق غير العادل للقانون.
إن هذه الممارسة، غير السوية، تجعل من المتهم المرجعي طرفا وخصما وحكما، فإليه يرجع توجيه الاتهام، فحتى الشاهد يملك القاضي حق تقييم شهادته ووزنها بميزان الحق والعدل، بل ويملك حق تجريحه، أما المتهم المعترف على غيره، فلا تملك حق رد تصريحه، ولا حق تجريحه، بالرغم من أن اعترافه على نفسه لا يمكن أن يسري قانونا وفقها وقضاء على غيره، لأن الاعتراف حجة قاصرة غير متعدية.
إن محكمة النقض سبق وأن اعتبرت غير ما مرة أن “أقوال متهم ضد آخر” تعد مجرد تصريح لا يرقى إلى درجة الدليل الجنائي ودعت القضاة إلى استعمال سلطتهم التقديرية في اعتماد “تصريح متهم ضد آخر”، عبر إخضاعها للتعليل والاستعمال العقلاني لوسائل الاثبات، وبتعاضد الأدلة، وتحري صدقها ويقينيتها، والابتعاد عما يبطلها من نية الكيد والانتقام، وليس للأهواء والرغبات، وفقا للمستقر عليه من عمل محكمة النقض.
الحقيقة أن هذه قرارات محكمة النقض على أهميتها لم تقطع مع المساطر المرجعية نهائيا وإنما يمكن القول أنها غيرت وفرملت بعض الممارسات المرتبطة بالعمل القضائي لقضاة النيابة العامة أو التحقيق أو الحكم، الذين أصبحوا حذرين في الاستناد إليها، لأنها أصبحت وحدها غير كافية لترتيب الآثار القانونية مالم تدعم بوسائل إثبات أخرى كوثائق مكتوبة أو اعترافات أو قرائن أو شهادات الشهود أو تقارير الخبراء أو معاينات، وبالتالي صار هاجس احترام قرينة البراءة حاضرا في الممارسة القضائية، لكن بالمقابل لازال هناك عملا قضائيا آخرا، يتحفظ على استعمال أي سلطة في تقدير هذه المساطر ويتعامل معها بقدسية تهدم حقوق وحريات أبرياء.
إن مبادرة المشرع من خلال مشروع القانون رقم 03.23، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ومن خلالها تنظيم وتقنين المساطر المرجعية من خلال العمل على تقوية دور القضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات، عبر إلزام القاضي بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي يصدره، أو من خلال عدم جواز أن تبني المحكمة قناعتها بالإدانة على “تصريحات متهم ضد متهم آخر” إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة، وتتلقى المحكمة في هذه الحالة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية، توجه يعكس وعيا عميقا وحرصا حقيقيا على فرملة أي توجه نحو الاعتماد الآلي ل”تصريحات متهم على آخر” كوسيلة إثبات، خاصة بعد دسترة مبدأ قريبة البراءة من خلال مقتضيات المادة 119 من دستور 2011، التي نصت على أنه: “يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به” وبعد تراكم عمل قضائي جريء سواء لمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف الذي استقر على أن “شهادة ضنين على ضنين” أو “متهم على متهم” لا تنهض دليلا كافيا للقول بالإدانة، فافتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها، أصلان كفلهما الدستور، فلا يجوز أن تأتي المحاكم عملا يخل بهما.
ولا شك أن المساطر المرجعية الرائجة بكثرة أمام المحاكم في الحقيقة تعد أكبر إشكال قانوني يتوجب التعاطي معه والبحث له عن حلول تنسجم والمقتضيات الجديدة والمتقدمة لدستور المملكة إذ لا يستقيم القول بالإدانة استنادا إلى تصريحات ضنين في مواجهة ضنين دون أن تكون تلك التصريحات معززة بأدلة وقرائن قوية حماية للحرية.
والقرائن القضائية أداة يعتمدها القاضي لتكوين استنتاجات من الوقائع المتاحة أمامه بناء على تقديره الشخصي، وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف النازلة وتقدير مدى دلالتها فيها.
والتعديل المرتقب حتما ما هو إلى تضمين وتقين لمجموعة من القواعد التي كرسها العمل القضائي، فقد سبق وأن صدرت قرارات كثيرة كلها تقيد وتفرمل أي توجه للاعتماد الآلي لتصريحات متهم على آخر كوسيلة إثبات للقول بالإدانة، وهكذا جاء في قرار لمحكمة النقض:
“… لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها بالإدانة على تصريحات متهم ضد متهم آخر إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة وتتلقى المحكمة هذه التصريحات دون أداء اليمين القانونية...”.
في قرار صريح أكدت محكمة النقض أن “… شهادة متهم على آخر يرجع إلى السلطة التقديرية لقضاة الموضوع الذين لهم كامل الصلاحية في الأخذ بها أو استبعادها، وعليه تكون المحكمة لما ارتأت عدم الأخذ بشهادة الظنين خاصة وأنه تراجع عما صرح به تمهيديا قد استعملت سلطتها التقديرية“.
قرار عدد 2281/4، ملف جنحي عدد 97/27959، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 55، ص. 368.
وفي قرار آخر: “شهادة متهم على متهم لا تجوز ولا ترقى إلى درجة الشهادة لعدم تطبيق مقتضيات المادتين 122 و123 من ق.م.ج وأن عدم وجود أدلة أخرى تعزز هذه التصريحات يجعل القرار المطعون فيه على غير أساس وخالف مقتضيات المادة 290 من ق.م.ج، الأمر الذي يعرضه للنقض والإبطال”.
قرار عدد 2403/3، صادر بتاريخ 05/11/2028، في الملف جنحي عدد 5084/6/3/2007.
“أن الطاعن أنكر في المحضر ولا يوجد بالملف ما يؤكد التهمة المنسوبة إليه ما عدا تصريحات المتهم الأول والتي تدخل في باب شهادة متهم على متهم وهي لا تجوز مما يبقى معه القرار عرضة للنقض“.
القرار عدد 639/3، المؤرخ في 28/02/2001، في الملف جنحي عدد 14178/2000.
ومن زاوية أخرى فإنه إذا كان دليل الإدانة الوحيد هو مجرد “شهادة متهم” فهذا يعني أن الشك هو سيد الموقف وبالتالي وعملا بقاعدة “الشك يفسر لمصلحة المتهم” على المحكمة ألا تقضي بثبوت الإدانة وإنما تقضي بالبراءة لأن عدم كفاية الأدلة يؤدي حتما إلى تسرب الشك إلى وجدان القاضي، فـ”شهادة متهم على متهم” التي لا يعززها أي دليل آخر تبقى ضعيفة ولا يمكن الارتكان أو الاستناد إليها للقول بالإدانة، وقاعدة “الشك يفسر لصالح المتهم” هي نتيجة طبيعية لقرينة البراءة يستفيد منها المتهم تعني بالضرورة أن النقص في قيام الدليل على عناصر الجريمة يؤدي حتما إلى الحكم بالبراءة.
فإن حصل شك للمحكمة في تقدير قيمة الأدلة أو شك في ثبوت التهمة فإنها تركن إلى تطبيق المبدأ الأصلي وهو “قرينة البراء” وهو مبدأ يلتقي مع قاعدة من قواعد القانون وهي أن “اليقين لا يزول إلا باليقين، أو كما يقال: “الدليل إذا تطرقه احتمال سقط به الاستدلال”.
إن “شهادة متهم على آخر” دليل أوهن من بيت العنكبوت، تحيط به الكثير من الشكوك، وضعيف لا يكفي، وغير مقبول لترجيح الإدانة على البراءة، فهي الأصل في الإنسان لا يمكن نفيه إلا بحجة قاطعة لا يرقى إليها الشك أو الافتراض، وبالتالي فإن المشرع، من خلال مشروع القانون رقم 03.23، الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، قد أحسن صنعا باعتزامه تقينين وضبط العمل القضائي بخصوص هذه الآفة لمزيد من الحماية للحقوق والحريات، ومزيد من التكريس لدولة الحق والقانون.
محام عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.