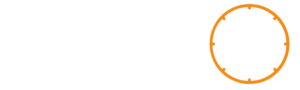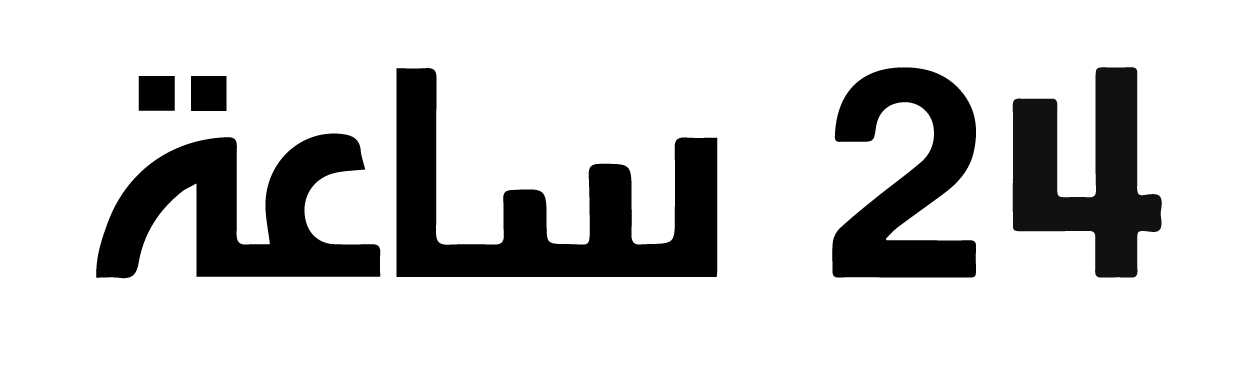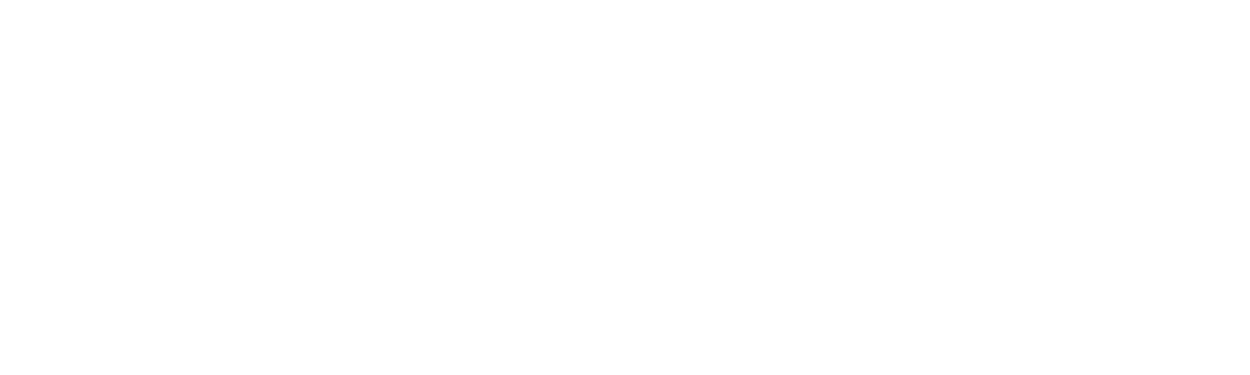إعداد-عبد الرحيم زياد
تقدم جريدة “24 ساعة” الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة حلقات تستعرض جوانب مضيئة من تاريخ المغرب الاجتماعي في القرن التاسع عشر، وذلك من خلال كتاب “المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر – اينولتان 1850-1912″ للمؤرخ والأديب المغربي أحمد التوفيق.
الكتاب عبارة عن رحلة عبر الزمن إلى قلب المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر، من خلال دراسة تاريخية اجتماعية عميقة، تسلط الضوء على فترة حاسمة من تاريخ المغرب، وتحديدًا منطقة “اينولتان”، خلال النصف الثاني من 19 وبداية القرن 20. وهي فترة شهدت تحولات جذرية نتيجة للضغوط الاستعمارية والتغيرات الداخلية التي عصفت بالمجتمع المغربي.
كما يتناول الكتاب فترة حكم السلطان الحسن الأول، وهي فترة زاخرة بالأحداث والتحديات التي ساهمت في تشكيل ملامح المغرب الحديث. ويقدم وصفًا دقيقًا للحياة اليومية للناس في “اينولتان” ، مركزًا على العادات والتقاليد، والبنية الاجتماعية، والاقتصاد المحلي. كما يسلط الضوء على تأثير العوامل الخارجية، مثل التجارة الأوروبية والضغوط السياسية، على المجتمع المغربي.
الحلقة24: الأسرة الكبيرة والتقسيمات القبلية في مجتمع إينولتان
ويترتب على ذلك أن الحرب والسياسة والزراعة والعدالة والجمال وحتى الولاية، كانت، لاعتبارات ما، ولدرجات مختلفة، قضايا عائلية، غير أنه لم يعد شيء من ذلك في يومنا هذا. وإذا كان لابد من تحديد ذلك الماضي، فلا يكون إلا أبعد من القرون الأربعة التي تغطيها وثائقنا .
أما النسق الانقسامي كما وصفه كيلنير، بالنسبة لحنصالة، فيفترض تساكن سلطة المرابط وسلطة حاكم القبيلة المنتخب لمدة محدودة، وهذا لا ينطبق على اينولتان خلال الفترة المدروسة. كما أن اينولتان لم يكونوا هامشيين، ولم يكن نسقهم محددا بسبب العصيان ضد السلطة المركزية، لأنهم كانوا خاضعين لها، وان وقع عندهم عصيان، فقد كانت له أسباب تاريخية ولم يكن عندهم نظاما ومؤسسة، بل ينبغي وضعه في سياق تاريخي محلي وعام ، وذلك ما سنتعرض له في الفصول التالية.
غير أن هؤلاء الباحثين قد اعترض جميعهم مشكل المصطلحات عند وصف الوحدات المختلفة الأحجام في التنظيم الاجتماعي للقبائل. ولم يترددوا مع ذلك في استعمال مصطلحات دارجة في علم اللاتنولوجية، وفي الاقتباس من المصطلحات الادارية الاستعمارية، ومن التسميات المحلية مرادفين بينها بشكل يثير الالتباس. فقد مال مونطاني إلى استعمال تقسيمات لها علاقة بالتجمعات السكنية، بينما لاحظ بيرك أن أهل سكساوة لا يميزون بين القرية الصغيرة والقرية الكبيرة، وأنهم كانوا يستعملون «الموضع » وهي تسمية عربية فارغة .. بينما نجد هارت يستعمل العشير لترجمة الربع عند بني ورياغر في الريف. كما أن تاقبيتش عنده ليست هي تقبيلت التي ركز عليها مونطاني وبيرك في الأطلس الكبير، بل هي ما يرادف عندهم القبيلة أي مجموع بني ورياغر .
وعندما نكتب بالعربية، فاما أن نلتجئ مباشرة إلى القاموس العربي لنختار ألفاظا مناسبة» للتقسيمات المحلية، وبذلك نسقط التقسيمات القبلية للرحل على تنظيم المستقرين ونقع في خطأ تزكية تعابير الاخباريين والموثقين وحتى في الاستعمال الشفوي لكلمة تا قبيلت، مثلا، واما أن نلجأ إلى ترجمة مصطلحات الباحثين الأجانب
وبذلك نترجم إلى العربية، ترجمة غير صحيحة، مصطلحات لا تطابق التقسيمات الفعلية للقبائل، وهنا نقع في خطأ مركب. فإذا رجعنا إلى «لسان العرب» لابن منظور، نجد أن التقسيمات القبلية غير دقيقة، سواء في مضمونها أو في درجاتها، فلا نميز بشكل واضح بين الفصيلة والعشيرة، ولا بين العمارة والبطن والفخذ الخ. ولكن، بما أننا لا نرمي من وصف تقسيمات اينولتان إلى مقارنات واسعة، فإن مشكل المصطلحات يبدو أقل حدة وإلحاحا.
تقسيمات إينولتان :
الأسرة : إن الخلية الأساسية لمجتمع إينولتان لم تكن هي «إيخص» أي العظم» كما كان الشأن بالنسبة لسكساوة، بل هي الأسرة الكبيرة المكونة من أبوين وأبناء متأهلين وذريتهم، أو من إخوة وأزواجهم وأولادهم، مجتمعين في مسكن واحد، ومشتركين في الانتاج بشكل تعاوني، يعرف فيه كل مهمته، وربما اختصاصه. وعلى سبيل الإيضاح نرى من المفيد أن نورد وصف اينجلز للعائلة الكبيرة، التي كانت الشكل السائد في كثير من بلاد العالم إلى وقته حيث يقول : «مع الأسرة الأبوية ندخل في مجال التاريخ المكتوب .. وقد كونت كما نجدها اليوم عند السرب والبلغار تحت اسم زادروكا وتحت صورة مغايرة عند شعوب الشرق، المرحلة الانتقالية بين الأسرة القائمة على حق الأم، الناتجة من الزواج الجماعي، وبين الأسر الزواجية في العالم الحديث.
فالزادروكا» عند سلافيي الجنوب، تعطي أحسن مثال حي لمشاعة عائلية من هذا النوع ، وهي تجمع عدة أجيال من سلالة نفس الأب ، يسكنون جميعا مع نسائهم في ضيعة واحدة، يزرعون جميعا حقولهم، ويملكون مشتركين فائض منتجاتهم. وتوضع المشاعة تحت إدارة عليا لسيد الدار، الذي يمثلها في الخارج، ويتمتع بحق تفويت أشياء ذات قيمة قليلة، ويتصرف في المال، وهو المسئول عنه وعن تدبير شئون الدار، وهو منتخب، وليس بالضرورة عميد الدار. أما النساء وأشغالهن، فتحت إدارة سيدة الدار التي هي في العادة زوجة سيد الدار، وكلمتها مسموعة بل ربما كانت حاسمة في اختيار أزواج للبنات. ولكن السلطة العليا هي لمجلس العائلة، المكون من كهول الرجال والنساء، وله يقدم سيد الدار الحسابات، وهو الذي يتخذ
القرارات الحاسمة ويمارس القضاء بين جميع أفراد المشاعة، كما يقرر في بعض المشتريات والبيوعات المهمة وخاصة ما يتعلق بالملكية العقارية الخ.
وإلى اثنتي عشرة سنة مضت وقع البرهان على استمرار هذه الأسرة الكبيرة في روسيا أيضا». ويذكر اينجلز كذلك أن الوحدة الاقتصادية التي عرفها الجرمان، لم تكن في الأصل هي الأسر الزواجية بالمعنى العصري، بل كانت هي الشركة العائلية المتكونة من عدة أجيال أو من عدة أسر زواجية، والتي كانت في الغالب تضم العبيد أيضا. وكذلك كانت عند الرومان والهنود كما ظلت معروفة في بلاد القبائل الجزائرية .