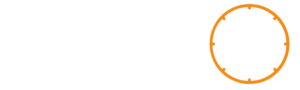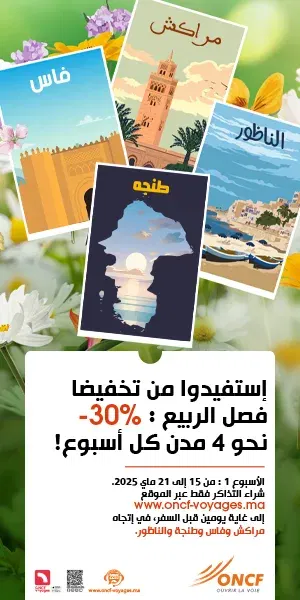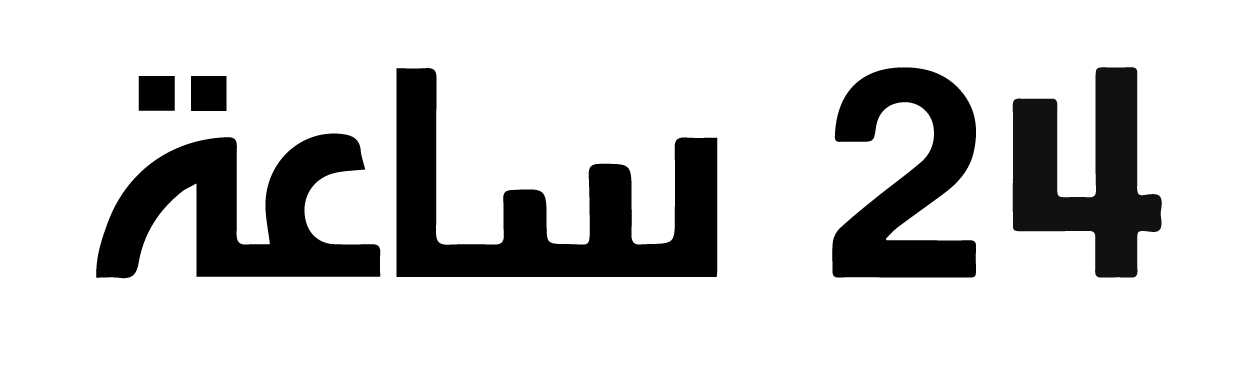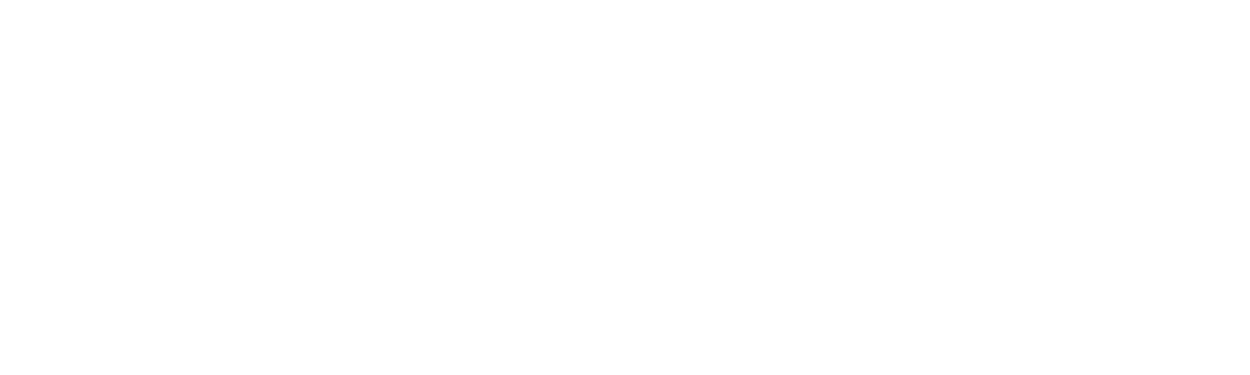24 ساعة-عبد الرحيم زياد
تقدم جريدة “24 ساعة” الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك، سلسلة حلقات تستعرض جوانب مضيئة من تاريخ المغرب الاجتماعي في القرن التاسع عشر، وذلك من خلال كتاب “المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر – اينولتان 1850-1912” للمؤرخ والأديب المغربي أحمد التوفيق.
الكتاب عبارة رحلة عبر الزمن إلى قلب المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر، من خلال دراسة تاريخية اجتماعية عميقة، تسلط الضوء على فترة حاسمة من تاريخ المغرب، وتحديدًا منطقة “اينولتان”، خلال النصف الثاني من 19 وبداية القرن 20. وهي فترة شهدت تحولات جذرية نتيجة للضغوط الاستعمارية والتغيرات الداخلية التي عصفت بالمجتمع المغربي.
كما يتناول الكتاب فترة حكم السلطان الحسن الأول، وهي فترة زاخرة بالأحداث والتحديات التي ساهمت في تشكيل ملامح المغرب الحديث. ويقدم وصفًا دقيقًا للحياة اليومية للناس في “اينولتان” ، مركزًا على العادات والتقاليد، والبنية الاجتماعية، والاقتصاد المحلي. ويسلط الضوء على تأثير العوامل الخارجية، مثل التجارة الأوروبية والضغوط السياسية، على المجتمع المغربي.
الحلقة 2: “اينولتان” : التحولات الاقتصادية والاجتماعية في فترة ما قبل الموحدين
لعل هذه الصيرورة البطيئة نحو الاستقرار، مما يفسر عدم ورود دمنات كمركز تجاري في كتابات الجغرافيين كاليعقوبي وابن حوقل والبكري والادريسي وكلهم تحدثوا عن أغمات وداي وربما حتى عن تدغة. ويستفاد مع ذلك من وصف البكري في “المسالك والممالك”، أن هسكورة كانوا يراقبون الطريق بين سجلماسة وأغمات لوقوعهم على طول مسافة أربعة أيام بين ورزازات وزركطن عبر ممر تلوات، كما كانوا يراقبون الطريق بين أغمات وداي ثم فاس لمرورها ببلد تيفت الهسكوريين حيث تحدث البكري عن بني وارث.
وقد تساءل كودينو، عن الفترة التي كانت فيها الطريق الرابطة بين سجلماسة وأغمات عن طريق تدغة قدمنات مطروقة لأنها لم ترد عند هؤلاء الجغرافيين الأولين، رغم قصرها وكونها صارت جد مطروقة فيما بعد. وربما كانت لها أهمية أكبر قبل خلاء تدغة بعمارة سجلماسة خاصة وأن تدغة وهي قريبة من دمنات ظلت مرتبطة بها من الناحية التجارية طوال العصور. فقد عرفت تدغة في القرن الثاني وبداية القرن الثالث للهجرة ازدهارا اقتصاديا في ظل إمارات محلية ثم تحت التبعية الحاكم تادلا من بني ادريس، حسب ما تبين من الأبحاث الأخيرة للباحث أوستاش. أما ممر تيزي ن فدغات المباشر بين واد دادس وبين اينولتان فيظهر أنه كان، قبل أن يُصبح تيزي ن اتكارن (ممر التجار ) الذي سمي به يُدعى تيزي نايت بوولي» أي ممر رعاء الشاء حيث ما تزال قبيلة آيت بوولي بين هذا الممر وبين اينولتان إلى اليوم.
ب – تكون الاتحادية والتوسع عن طريق الدفع :
فمن هم رعاة هسكورة وما أصل اتحاديتهم ؟ أن أقدم النصوص المكتوبة، رأت في هسكورة، كما رأت في غيرهم من المجموعات القبلية، أبناء جد مشترك واحد، وأقامت بناء على ذلك بين أجزاء المجموعة أنسابا بالغت في تدقيقها وتفريعها لمدافعة الشك، منتهية بالنسب، الأعلى إلى أصول حامية أو سامية. وغير خاف أن الكثيرين إنما جروا في تفسير أصول قبائل المغرب على مجرى كتب الأنساب التي كانت قد حددت نظرتها وأسلوبها قبل مباشرة الواقع المغربي.
وقد شكك بيرك في أن يكون للمضمون القبلي وجود واقعي يتعدى رمزية لغوية تمثلها هذه الأسماء الوسطوية لمجموعات القبائل، وتبنى العروي هذا الشك واستخلص من إحدى المناقشات البارزة في كتابه عن تاريخ المغرب الكبير أن البنية القبلية ليست أصيلة، ولكنها عاقبة اجتماعية وسياسية لضغوط الوجود الروماني في شمال افريقيا، حيث رجع المستقرون إلى الترحل، فاستدام ذلك وتمثل في البنية القبلية، وفي تقسيماتها التي ليست سوى صياغة ايديولوجية وجواب على حصار تاريخي. وبالرغم من كون العروي، لا يرى فائدة في تحديد مجالات هذه التقسيمات القبلية وتتبعها، فإننا نعتبر من المفيد الاتيان ببعض عناصر هذه المسألة في مجال در استنا.
لقد ظلت روايات شفوية، متعلقة بتاريخ درعة قبل الإسلام، متداولة عند الأجيال إلى قرون متأخرة، حيث سجلها كتاب من المسلمين واليهود في عين المكان، ففي سنة 1143هـ (1730م) كتب محمد المكي بن موسى الناصري، في طليعة الدعة ما يلي : وجدت في بعض التقاييد ولا أقطع بصحته ولا نفيه ما نصه : هذا تقييد بعض تواريخ واد درعة ويسمى أيضا واد الزيتون لكثرة الزيت به. أعلم أن وادي درعة واد بأقصى المغرب يتفجر من جبل درن. وقدمه من عهد كوش بن كنعان بن حام بن نوح .. وكان كوش على دين المجوس، وجيشه أربعون ألفا من الزعام. وكان غالبه على جميع أهل المغرب ثلاثمائة سنة، حتى غلبت النصارى على بني اسرائيل..». والتقييد الذي نقل عنه الناصري، وتردد في الوثوق به، هو من دون شك نسخة من تلك النسخ العديدة التي كانت بأيدي يهود درعة من كتاب عن تاريخهم القديم، وصراعهم مع النصارى ثم مع المسلمين في تلك المنطقة. وهذا التاريخ تسجيل لرواية شفوية عن أحداث جرت قبل الإسلام، جمعت في كتاب في العهد المريني، وظلت نسخها محفوظة في عدد من بيع المغرب إلى بداية القرن العشرين.
. وقد قارن الباحث كاتفوسي بين نسختين من هذا التاريخ وقف عليهما وخرج باستنتاج يتمثل في وجود علاقة بين الكوشيين الأحباش، الذين تحدثت عنهم رواية تاريخ يهود درعة، وبين الحراثين (أو الحراطين المنتشرين ما بين تافيلالت ودادس ودرعة وفي نواحي المغرب. ورأى أن الكوشيين عرفوا مجدا غابرا ونفوذا تعدى تخوم الصحراء إلى شمال جبال الأطلس.