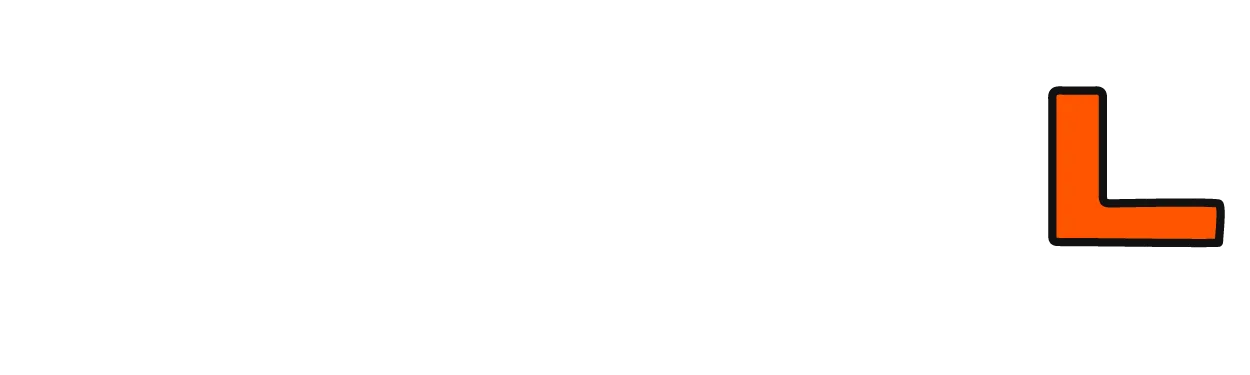محمد ميرة
إننا نعرض هنا قضية الديمقراطية و الانتخابات من باب غير تقليدي؛ فلن نستغرق في الجدل المعتاد حول تعريفهما و تطورهما وأشكالهما ومكانتهما بين مصادر شرعية النظم السياسية، لكن نتعامل معهما باعتبارهما حقا للمواطن المغربي ينبغي ترسيخه وتعزيزه وصيانته ، صحيح أن معظم البلدان منذ حصولها على الاستقلال– أشكالاً متباينة من الانتخابات، بل إن بعضا منها التزم بدوريتها وأعطاها درجة من التنافسية، لكن ذلك لم يكن -في الغالب- غير وسيلة لإعطاء الأنظمة الحاكمة الشرعية الشكلية تتصدى بها للمعارضات الداخلية أو لتحسين صورتها أمام العالم الخارجي، بل إن إجراء الانتخابات تحول في بعض الحالات إلى حالة اعتياد موسمي لا عائد ديمقراطيا منها.
فالديمقراطية في فهمها العام هي كما عرفها إبراهام لنكولن هي حكم الشعب، من قبل الشعب، ومن أجل الشعب، يعتبر هذا التعريف الأكثر شيوعاً لمفهوم الديمقراطية كنظام للحكم ، بيد أن هذا التعريف لا يعبر بشكل دقيق عن الأنظمة السياسية التي سادت عالمنا، واعتنقت مفاهيم مختلفة للديمقراطية، نتيجة تفسيرات مختلفة لهذا المفهوم السياسي الذي يعتبر محور الفكر السياسي في العالم. أما الديمقراطية في فهمها الفلسفي هي حرية الفرد والمجتمع في الخيار والاختيار المتصل بكل نواحي الحياة دون أن نضع حدود لهذه الحرية إلا تلك التي تنظم الممارسة الديمقراطية نفسها، لقد وضعت الديمقراطيات الحديثة الكثير من الخطوط والضوابط للممارسة القصد منها عدم الانفلات من فلكية الفهم الديمقراطي وبالتالي حماية مجتمعاتها وأفرادها من الأفكار والرؤى التي تتناقض مع الديمقراطية وشروطها وصاغت لذلك قواعد ومفاهيم تتعلق بالمواطنة والمشاركة وأجملتها في سلسلة طويلة ومتنوعة من الحقوق والواجبات أرستها عبر تجربة طويلة.أما الانتخابات في سياقها الدلالي والتداولي الديمقراطي أن تقوم على مبدأ حق الشعب باختيار من يحكمه في حالة وجود أكثر من حزب أو شخص أو جماعة ، فيختار الشعب الأفضل والأجدر بالحكم سواء تعلق الأمر بانتخابات الهيئات المحلية أو الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، ومن هنا اقترن مصطلح الانتخابات بالديمقراطية التي تعني حكم الشعب أو حكم مراقب من الشعب وبرضاه فيما أن الديمقراطية تعني حكم الشعب وحيث لا يمكن عملياً ومنطقياً أن يحكم كل الشعب فكانت آلية الانتخابات ليختار أو ينتخب الشعب من ينوب عنه لتولي السلطة والحكم .
هذه العلاقة الحتمية أو التلازمية بين الانتخابات والديمقراطية، فقدت جاذبيتها في الحياة السياسية لأسباب متعددة منها: صيرورتها لعبة الطبقة السياسية المهيمنة والناخبين الكبار، وبسبب قوة حضور أيادي خفية التي هي فوق العملية الانتخابية وتؤثر فيها كثيراً،و أيضا انشغال الشعوب بالأزمات الاقتصادية المحلية والدولية، كل ذلك جعل من المستساغ والمقبول أن يتساءل البعض و نتسأل حول جدوى الانتخابات عندما لا تؤدي لتجديد الطبقة السياسية أو تسمح بتغول المال السياسي الانتخابي؟ لكن هل الخطورة تكمن في حلول المال السياسي الانتخابي فقط ؟ أم هناك عامل أخر أكثر خطورة و أكثر قوة و نفوذا يعتمد أساليب لاديمقراطية في إقرار خريطة سياسية معينة على المقاسات التي تخدم مصالحها غير الديمقراطية؟ وما مدى استجابة النظام الديمقراطي ببنيته -التشريعية والقضائية و التنفيدية- للتعبير الجاد والأمين عن الإرادة الشعبية؟
هد الموضوع ليس محاولة للإجابة بقدر ما هو عملية لطرح الأسئلة،على الآخرين وعلى دواتنا ما دمنا نريد تفسير الحاضر انطلاقا من تجارب الماضي و تفسير الماضي كخط سير نحو الحاضر و نحن ندرك الصعوبة التي تنتظرنا خلال هذه الممارسة و ندرك أيضا إن الاعتراضات ستكون كثيرة و لكن كل ذلك لن يمنعنا من البحث، حتى نستطيع تفسير معضلتنا السياسية الحالية و عناصر الأزمة المختفية من خلفها .و لكن هل أصبح محظورا علينا نحن الجيل الذي لم يعش كفاح الحركة الوطنية و سنوات الرصاص و النضال من اجل الخيار الديمقراطي أن تراجع تاريخ هده المسيرة ؟
إن المهمة ليس سهلة، و في نطر “الكبار” نحن لسنا أكفاء لممارسة ذلك ،غير أننا نعرف أيضا أن التاريخ ينبغي ان لا يكون كلاما في ترتيب الحوادث بل محاولة للتصدي للمرحلة علميا، ان مؤامرة الصمت من جانب المسؤولين لا يمكن أن تعتبر سوى نتيجة حتمية للتفكير الانتقائي البرجوازي الذي تضلله الأوهام الفردية و الطهارة الذي أعطى الدليل مرارا على عجزه عن رؤية المضمون التاريخي للمرحلة .
كمتتبعين للشأن السياسي بالبلاد نلاحظ و خصوصا نحن على موعد بالانتخابات المحلية و البرلمانية لهده السنة هذا السباق العجيب في اتجاه حصد المقاعد البرلمانية على الخصوص، بحيث تستعمل هذه المؤسسات الحزبية كل الوسائل المشروعة منها وغير المشروعة في سبيل تحقيق غاياتها الانتخابية ولو على عاتق الديمقراطية، ويتجلى هذا الأمر واضحا من خلال العينات التي نراها بدأت تستعد للترشح باسم هذه الأحزاب والتي يدخل معظمها ضمن خانة، الباطرونات / أصحاب الشكارة ومن أهم الأسس الضامنة لهذا الاضطراب تلك الكائنات الانتخابية التي تتحول مع مرور الزمن إلى ديناصورات انتخابية تتحكم في النتائج أشهرا قبل الاقتراع العام، بواسطة حفنة من السماسرة على اختلاف مواقع تواجدهم من الهرم المجتمعي ودرجاته، والتي أضحت تملك أزرار تحريك الكتلة الناخبة حسب الإملاءات الفوقية لأصحاب القرار، خاصة وأن أغلب هؤلاء يدخلون في خانة الأعيان والأعوان أو بتعبير أقرب أصابع السطة الاقليمية الذين تسخرهم لتغليب كفة خدامها على كفة أخرى من المرشحين للانتخابات على اختلاف مستوياتها.
هذا الهجوم على الديمقراطية بدأ منذ سنوات، في محاولة لإرجاع عقارب الزمن إلى الوراء، لتدجين الأحزاب الديمقراطية ومحاولة نسف كل الأحزاب التي تدافع على هذا الحق ، وفرض أجندات وأغلبيات مهترئة وهشة على المجالس الجهوية ، وضخ مشاريع وأموال للجهات الموالية لتوجه معين، بالإضافة إلى تنامي الفساد والمحسوبية، وانتظارات الشارع في ما يخص التشغيل والصحة والتعليم و إضعاف ساعد الطبقات الشعبية و هذا ما من شأنه تأبيد سياسات التهميش و التفقير و التجويع.
و لكي لا يكون كلامنا هذا كلاما تجريدي للغاية و غير محسوس يسهل على كل ضليع في الانتكاسة التي تتعرض لها الديمقراطية في بلادنا و بالتالي تأويله حسب هواه محاولا درء الشبهات عنه و درء الرماد في الأعين نستشهد بواقع ملموس حيث تم اغتصاب الديمقراطية امام مرئ و مسمع كل الحقوقيين و النشطاء الغيورين على هذا الحق التي حصن بدماء الشهداء عبر تاريخ طويل من النضال و التضحيات، واقع غياثة الغربية او مأساة غياثة حيث لحضنا كمهتمين بشأن السياسي ماحدث بهاته الرقعة الجغرافية من اغتصاب لديمقراطية بالإلغاء لعدد من الأعضاء لعضويتهم بالمجلس الجماعي رغم أنهم لم يكونوا أي موضوع طعن في الانتخابات التي لم يشبها اي تزوير بشهادة جميع المراقبين و تعيين مجلس جديد على رأسه رئيس قديم جديد سبق و أن ترشح في الانتخابات الجزئية التي جرت سنة 2017 و لم يحصل إلا على مقعدين من اصل 27 لإشارة فقط هذا الأخير متابع قضائيا بجرائم الاختلاس و تبديد المال العام بعد أن تربع على عرش هده الجماعة أزيد من ربع قرن، فهذا هو حال الديمقراطية بغياثة الغربية منذ بدايات الانتكاسة و حتي كتابة هذه السطور.. بين مجلس قديم يحاول الاستنساخ ،و أعضاء أخشى أن يكونوا قد نسوا المهام ، و بيادق لاتجيد الا لعبة القط والفار , وحزب عبثا يحاول البقاء ،, وبرلمان مات لانه ولد مصاب بمرض التوحد نتيجة خلل في الجينات ، وأحزاب فاشلة كرتونية متشابهة الاسامي لا يعرف احد أسمائها غير مؤسسيها الرؤساء لا يجيدون حديثهم إلا بأصبع السبابة أجوف أصم بين هذا وذاك ، ومسئولين و خردة يمتازون بأنصاف الصفات فاقدون لكاريزما المنصب وجهلاء الإلمام ، وإعلام وإعلان مأجور يسوق سلعته بتفاهة و الكذب، ومثقفون ونخب لا يجيدون التحليق الا في الليل كخفافيش الظلام ، وأيادي نافد بالإقليم تحاول قلب الموازين لتكريس الأقدام بضخ الأموال، وغضب ساكنة يحاولون طمسه من اجل تحقيق اهدافهم السوداء ، لكل …..الكل يريد احباط حزب شهد له العالم وتغنى به الزعماء وكان حديث كبار الكتاب.
هكذا أصبحت الساحة الانتخابية بغياثة و بالبلاد بشكل عام تعج بهذه الكائنات التي تقف مانعا أمام التعبير الحر لها في اختيار ممثليها بالمجالس او البرلمان ، من خلال تأثيرها بواسطة المال أو بعض الخدمات الاجتماعية والتي غالبا ما تكون خارج القانون، في استمالتها للتصويت لفائدة أشخاص بعينهم، لذلك تكون المنافسات الانتخابية على الطابع غير ديمقراطي، مما يستحيل على ضوئه التكهن بالنتائج المرتقبة للانتخابات، كما تصعب معرفة الحزب الذي ترجح كفته للفوز في الاستحقاقات طالما أن هذه الأخيرة محكومة بمنطق المال والامتيازات والتدخلات غير المشروعة للسلطة المحلية و الإقليمية ، ويمكن القول بأن هذه الظاهرة قد رفعت عن العملية الانتخابية قدسيتها، وحولتها إلى مجال للمزايدة والمتاجرة، يتحكم فيها منطق العرض والطلب، وحولت المعركة الانتخابية من ساحة للمنافسة الديمقراطية بين الفعاليات السياسية التي تتقارع عبر برامج انتخابية واقعية تدفع في اتجاه تقدم البلاد إلى المستويات الديمقراطية التي تؤهلها للاندماج الفعلي والفاعل في المنظومة التي تحكم العالم، إلى سوق انتخابية تتحكم فيها سلطة المال ، يتسابق فيه الأعيان والأعوان على مرأى ومسمع من السلطات الإقليمية التي ترعى و تبارك من جهتها هذا السلوك النشاز في سفينة الديمقراطية و التي بدورها تختار بعناية هؤلاء الأعيان و أصحاب الشكارة لكل و قربه من الدائرة السلطة ومدا ولائه لها
فتنامي هذه الطفيليات داخل المشهد الانتخابي المغربي مراده غياب إرادة سياسية واضحة المعالم تمكن من تفعيل القنوات القانونية الزجرية للحد من تناسل هذه المظاهر المسيئة للتقدم الديمقراطي للبلاد، و ذلك نتيجة للسياسية العامة التي تنهجها الدولة والمبنية أساسا على تشويه ملامح المشهد السياسي الوطني، باعتمادها الأساليب لاديمقراطية في إقرار خريطة سياسية على المقاسات التي تخدم مصالحها غير الديمقراطية.و لهذا فحماية الديمقراطية كانت و ستظل ربقة في عنق كل الغيورين عنها .
إن سؤال الديمقراطية المطروح حاليا لا ينصب فقط على بناء نظام ديمقراطي يستجيب للمعايير والشروط، ولكنه يشمل مدى استجابة النظام الديمقراطي -ببنيته التشريعية و القضائية و التنفيدية- للتعبير الجاد والأمين عن الإرادة الشعبية، كما يتصل بتلبيته لإقامة بناء نظام ديمقراطي رشيد يعمل لصالح الشعب ممثلًا له ومديرا لشئونه وخاضعا لرقابته
و يبقى السؤال مطروح هل تمتلك الدولة أليات المواجهة هذا العبث؟، هذا ما ستجيب عنه الايام القادمة.